كيف نحيا ببطءٍ شعري في عالمٍ سريع؟ 🐢
زائد: هل ينتج الذكاء الاصطناعي معرفة حيادية؟
يبدو أن إيلون مسك لا يكتفي بإعادة تشكيل صناعة السيارات أو الفضاء، بل يريد أيضًا إعادة كتابة الحقيقة ذاتها. 🤨
إذ أطلق مسك الموسوعة الرقمية «قروكيبيديا» بدعوى تقديم معرفة أكثر حيادًا وموضوعية، لكنها في جوهرها تعكس انحيازاته الخاصة، حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي كأداة لإعادة صياغة المعلومة وفق رؤيته، في محاولة لإلباس الرأي ثوب الحياد التقني. والمفارقة أن «قروك»، النظام الذكي الذي يقف خلفها، يستمد محتواه أساسًا من ويكيبيديا الأصلية التي يسعى مسك إلى تجاوزها.
في النهاية، ما تبدو موسوعة «أكثر ذكاءً» ليست إلا نسخة رقمية من التحيّز البشري. 🤷🏽♂️
في عددنا اليوم، تكتب آلاء حسانين عن الشّعر كطريقة في العيش ووسيلة للتمهل في عالم تفوق سرعة تطوراته قدرتنا على الفهم. وفي «شباك منور»، تشاركك مجد أبودقَّة تجربتها مع قراءة كتاب ساعدها في فهم أمومتها الجديدة بعد ولادة رضيعتها. ونودعك في «لمحات من الويب» مع اقتباس يذكرك بأن كل ما تتصوره يمكنك تحقيقه، وكيف تتكيف سمكة الجليد مع ظروف بيئتها الصعبة. 🐟
خالد القحطاني

كيف نحيا ببطءٍ شعري في عالمٍ سريع؟ 🐢
آلاء حسانين
قد يبدو الحديث عن البطء في هذا الزمن نوعًا من الحنين إلى الماضي أو كأنه رفاهية لم تعد ممكنة. فالعالم يتغير بسرعة تفوق قدرتنا على الفهم، وكل ما حولنا يدفعنا إلى الركض. نحيا كما لو أن التأخر خسارة، وأن الوقوف للحظةٍ واحدة يعني أننا تخلّفنا. ومع ذلك، ثمة شيء في داخل الإنسان يقاوم هذا الإيقاع، يبحث عن فسحةٍ صغيرة من السكون، عن وقتٍ نسمع فيه أنفسنا بوضوح، عن لغةٍ لا تُقال على عجل. في تلك الفسحة يولد الشعر.
القصيدة ليست ترفًا، بل مساحة بطيئة نتنفس فيها من سرعة العالم. وحين نقرؤها، لا نفعل ذلك لأننا نملك وقتًا فائضًا، بل لأننا نحاول استعادة ما خسرناه في زحمة الوقت. فالشعر لا يقدّم لنا إجابات، بل يوقفنا عند الأسئلة، عند لحظة الإنصات قبل أن تندفع الكلمات. إنه تمرين على البطء، على الإصغاء لما لا يُسمع وسط الضجيج.
حين كتب ميلان كونديرا (Milan Kundera) روايته «البُطء» (La lenteur)، كان يعرف أن السرعة ليست مجرد طريقة للحركة، بل حالة وجود، إذ قال إن «الدرجة التي نقيس بها سرعة الزمن هي نفسها التي نقيس بها النسيان». فالبطء، في نظره، صنف من أصناف الذاكرة، والركض المتواصل طريق إلى النسيان. ومن يركض كثيرًا لا يتذكّر، لأنه لا يرى ما يمرّ عليه. وفي هذا المعنى، يشبه الشعر فعل التذكّر: تذكّر الأصوات، والظلال، واللحظات الصغيرة التي لم يتوقف عندها أحد. القصيدة تحفظ ما يمحوه الزمن السريع، وتعيد ترتيب الذاكرة بطريقة أكثر إنسانية.
لكن الشعر لا يتحدث عن الزمن فحسب، بل يغيّر الإحساس به أيضًا. يعلّمنا أن البطء ليس عجزًا بل وعي، كما كتب كارل أونوريه (Carl Honoré) في كتابه «في مديح البطء» (In Praise of Slowness): «أن تعيش ببطء لا يعني أن تفعل كل شيء ببطء، بل أن تفعل كل شيء بالسرعة المناسبة، بالإيقاع الذي يمنح أفضل النتائج.» أن نبطئ يعني أن نعيش بإيقاعنا الخاص، أن نستعيد حريتنا في عالمٍ يحاول ضبط كل دقيقة من يومنا. والقصيدة مثال واضح على ذلك، فهي تجعلنا خارج التقويم اليومي، خارج السباق، كما لو أننا نعود إلى الوقت الأول، إلى الإحساس الأصلي بالأشياء قبل أن تُسمى.
الشعر لا يغيّر الخارج، لكنه يغيّر طريقة وجودنا فيه. فهو لا يصلّح العالم، لكنه يجعلنا نراه بطريقة مختلفة. القصيدة لا تمنع الألم، لكنها تغيّر شكله، تجعله قابلًا للفهم والاحتمال. إنها توازن بين ما هو قاسٍ وما هو جميل، بين الفوضى التي نعيشها ومحاولة ترتيبها بالكلمات.
يرى الشاعر والناقد الأمريكي روبرت هاس في كتابه «ملذّات القرن العشرين» (Twentieth Century Pleasures) أن الشعر هو فنّ الانتباه؛ فنّ لا يُمارَس بسرعة لأن جوهره يقوم على البطء، على الإصغاء لما لا يُقال. فالشعر عند هاس لا يُقرأ على عجل، لأنه مصنوع من زمنٍ أبطأ ومن وعيٍ مختلف. حين نقرأ القصيدة، نبطئ دون أن نقرّر ذلك، لأن اللغة تأخذنا إلى إيقاعها الخاص. القصيدة لا تطلب أن نحلّها، بل أن نرافقها، كمن يسير بجانب نهرٍ لا يريد الوصول إلى نهايته. في تلك المرافقة يحدث شيء داخلي: يتبدّل النفَس، ويتغيّر المزاج، ويصبح العالم أقل حِدّة.
من المدهش أن الأبحاث الحديثة تؤكد أن الشعر لا يؤثر في العاطفة فحسب، بل في الجسد أيضًا. قراءة القصائد الإيقاعية يمكن أن تنظّم التنفس، وتخفف من التوتر، وتمنح نوعًا من الصفاء الذهني. وكأن الإيقاع الشعري يعيدنا إلى تناغمٍ بدائيّ بين الصوت والنَفَس، ربما لأن اللغة في أصلها كانت غناءً قبل أن تكون خطابًا.
حين تدخل القصيدة إلى يومك، فإنها تغيّر درجة الضوء قليلًا. لا تفعل ذلك بإضافة شيءٍ جديد، بل بجعل المألوف مختلفًا. قد تكون القصيدة سطرين فقط، لكنها تجعل الصباح أكثر صفاء، والمساء أكثر عمقًا. كأنها تذكّرنا بأن الحياة ليست في ما يحدث، بل في الطريقة التي نراه بها. الشعر يمنحنا هذا النوع من النظر، الهادئ والواضح، الذي يجعل العالم أقل قسوة.
ولأن الشعر يتعامل مع البطء، فهو أيضًا نوعٌ من الشفاء. ليس لأنه يُنهي الجرح، بل لأنه يتيح لنا النظر إليه دون خوف. القصيدة تساعدنا على البقاء مع ما يؤلمنا دون أن نغرق فيه. إنها تمنحنا المسافة التي نحتاجها لنفهم دون أن ننفصل عمّا نشعر به. لذلك يجد الكثيرون في الشعر نوعًا من العلاج الصامت، طريقة لتسمية ما لم يُسمَّ بعد، وللتصالح مع ما لا يمكن تغييره.
الشعر، في النهاية، ليس فنًّا لغويًّا فقط، بل طريقة في العيش. أن نقرأ الشعر يعني أن نتعلّم كيف نرى، كيف نبطئ، كيف نسمح للوقت بأن يمرّ دون أن نحاول السيطرة عليه. القصيدة تذكّرنا بأن الجمال لا يحتاج إلى إثبات، وأننا لسنا مطالبين بأن نفهم كل شيء، بل أن نحضر فقط. أن نكون هناك، في تلك اللحظة، بكامل وعينا.
حين نبطئ، نصبح أكثر رحمة. نرى الآخرين بوضوحٍ أكبر، ونسمعهم كما هم لا كما نريدهم أن يكونوا. والشعر يساعدنا على ذلك، لأنه يعيدنا إلى حسّ إنساني بسيط، إلى قدرتنا على الدهشة والإصغاء والشعور بالامتنان تجاه ما يبدو عاديًّا.
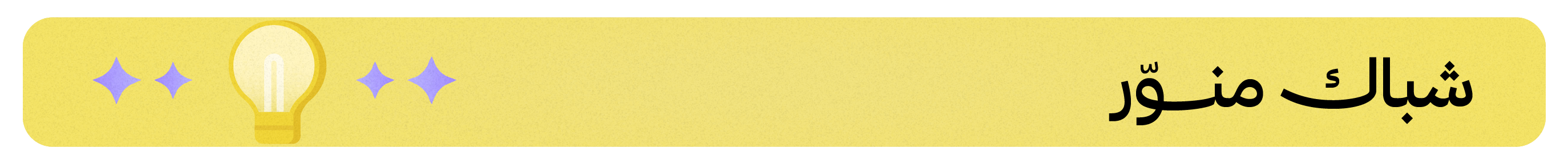

«حليب أسود» والنفس التي تؤسسها الأمومة🤱🏻
بعد ولادة طفلتي بأيام كانت تتنازعني أفكار ومشاعر كثيرة، بعضها متناقض والآخر مُرهق، ولأني لا أستطيع أن أفعل كثيرًا من الأشياء؛ فهي أيام تدور حول الاستشفاء والعناية بالرضيعة؛ لجأت إلى الكتب، وبطبيعة الحال أردت أن أقرأ شيئًا يُحاكي ما يدور في خلدي فبدأت قراءة كتاب «حليب أسود» لإليف شفاق.
كتبت شفاق هذا الكتاب بعد ولادتها الأولى، لتستعرض فيه كلَّ ما مرَّت به من تجارب عن الأمومة والكتابة، وما تنازعها من أفكار ومشاعر خلال تجربتها. ولم تكتفِ باستعراض ما عاشته بل جمعت تجارب كاتبات من كل الأجناس والعصور، وسردت كيف عشن الكتابة والأمومة والزواج، وعمّا تنازلت كلٌّ منهنّ لإبقاء الأهم بالنسبة لها.
قصدت شفاق في هذا الكتاب بيان الصراع الذي تخوضه الكاتبات عند اختيارهن بين الكتابة والأمومة أو محاولة القيام بالأمرين معًا، ولكني أرى أن شفاق -وإن أرادت التعبير عن إشكاليات الأم الكاتبة- قد عبرت عن بعض إشكاليات الأم العاملة، وحتى عن بعض إشكاليات الأم في كل أحوالها.
فأنا أظن أن هناك مشاعر فَقْد للذات وضياع وحيرة وربما عجز تتشاركها جلّ النساء في الفترة الأولى بعد ولادتهن، وقد عبّرت عنها شفاق بسرد تجربتها، قائلةً:
«وضعت مولودتي في سبتمبر 2006 م، أجمل شهور السنة في إسطنبول. كنت مبتهجةً ومغتبطةً، لكني محتارة أيضًا ولست مستعدةً. استأجرنا منزلًا صغيرًا في إحدى الجزر المحيطة بإسطنبول، حيث يمكنني إرضاع طفلتي والكتابة بهدوء. هذه خطتنا وتكشف لنا لاحقًا أني لست قادرةً على القيام بأي من الأمرين!
داهمني خوف خانق بأن أمرًا نهائيًا لا يمكن الرجوع عنه أو إبطاله قد ألمّ بي وأفسدني، ولم يعد بإمكاني العودة لما كنت. مخرتني موجة من الذعر، ورحت أظن بأنني الآن وقد صرت أمًّا وربة منزل، لن يعود بإمكاني كتابة الروايات. ومثل سجادة قديمة، سُحبت شخصيتي القديمة من تحت أقدامي.»
تخوض شفاق -كما كثير من الأمهات اليوم- رحلةً شاقةً في دواخل نفسها يتنازعها فيها شكلان من الحياة؛ أحدهما يدور حول ذاتها التي تعرف، والآخر حول ذاتها الجديدة التي تؤسسها الأمومة، لتجد في النهاية أن هذه الذات الجديدة تُوصلها حيث أرادت دائمًا؛ فشفاق تختم كتابها بقولها:
«في كل شيء كتبته وقمت به، كنت ولا أزال ملهمةً بزيلدا وزاهر -ولديها- وجماليات الأمومة وصعوباتها.»
إعداد 🧶
مجد أبودقَّة
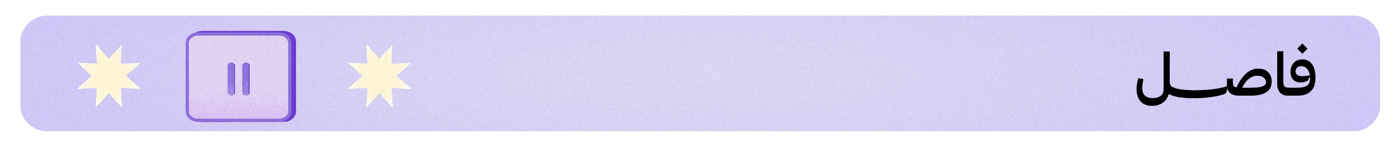
ادّخر بذكاء من كل عملية شراء 🧠
كل ريال تنفقه يمكن أن يصنع فرقًا في مستقبلك المالي.
«ادخار سمارت» من stc Bank حساب ادّخاري يعطيك 4% أرباح سنوية وتقدر تسحب فلوسك بأي وقت!
ادّخر اليوم، واستثمر في غدك مع «ادخار سمارت».
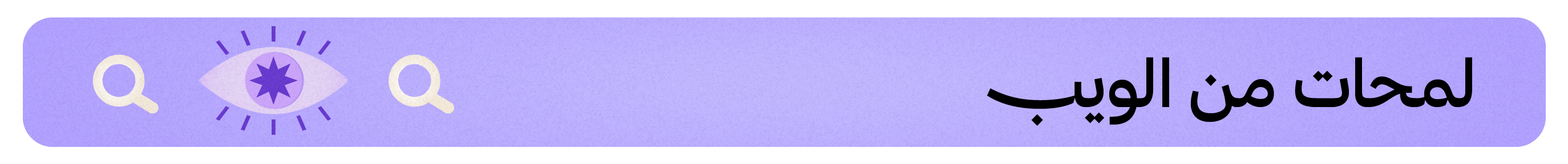
«كل ما يستطيع عقل الإنسان أن يتصوره ويؤمن به، فإنه يمكنه تحقيقه.» نابليون هيل.
تعرّف على سونق دونق، الفنان الذي احتفظ بكل شيء امتلكته عائلته.
كيف تنجو سمكة الجليد في المياه المتجمّدة؟
كل رحلة تبدأ بخطوة.
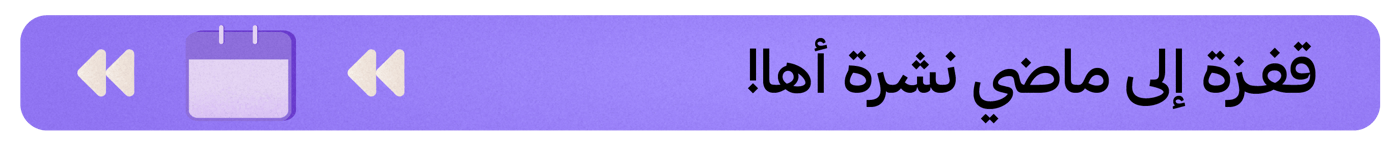
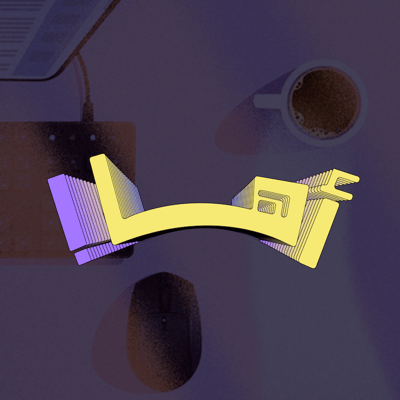
نشرة يومية تصاحب كوب قهوتك الصباحي. تغنيك عن التصفّح العشوائي لشبكات التواصل، وتختار لك من عوالم الإنترنت؛ لتبقيك قريبًا من المستجدات، بعيدًا عن جوالك بقية اليوم.