الدخون الدوسري أكثر من عطر
البخور تاريخ حضارات وقصة تجارة
يتفق العلماء أن الروائح من أقوى محفزات الذاكرة لدى الإنسان؛ قد تشم رائحة عطر في لحظة فتعود بك إلى زمن مضى.
ويهتم الأنثروبولوجيون بالعطر ليس سلعةً فقط، بل رمزًا اجتماعيًّا يحمل دلالات تتجاوز سعره. ففي الثقافة الخليجية مثلًا، يدخل العطر ضمن اقتصاد الهدايا.
وفي هذه المقالة نتناول الدخون بوصفه ذاكرة حضارية ورمزًا ثقافيًّا.
نوّاف الحربي


سيدات الفاو دخون المنقوعات في العطر
أمل الفاران
نشأت في بيت طين لم يكُن فيه غرفة نوم إلا حجرة أمي، وكان إخراجي أنا وأشقائي منها مهمة شبه مستحيلة. كانت غرفة الأمان وموضع الكنوز الصغيرة… والرائحة العطرة. تصحو أمي مع أذان الفجر فتحرّك بلطف صحن الحمسة في زاوية حجرتها فيثور الطيب. كانت تخرج لتُعدَّ لنا الفطور ولأبي القهوة، ثم تعود بمبخرة يتّقد فيها الجمر فتضع عليها حبّة دخون بحجم الزيتونة، فيتضبّب فضاء الحجرة بالبياض، وتلامس، ألسنةُ الطيب السقف. تدسّ المبخرة تحت ضفائرها، لتتخلّل أنفاسُ البخور شعرَها، ثم تحت ثيابها، فيتسلّق الطيب ذيل الثوب ليطلَّ من فتحة الصدر. في النهار ترشّ من علبة مخلّط عطرًا لونه أقرب إلى الحُمرة على مواضع النبض في عنقها ومرفقيها وفي الصدر. وفي الليل، من مرشٍّ آخر، تعطِّر فراشها بخليط أخفّ قوامًا ولونًا.
يوم الخميس تمشّط أمي شعرها بالسحون¹. وفي الأعياد، أو في مناسبات تخصُّها، تُخرِج الرداء؛ قطعةُ قماش غامقة اللون بأبعاد مترٍ في متر، تغمسها في خلطة عطور ثلاث ليالٍ، لتَفرِدها في الرابعة على مخدتها.
مع كل هذا العبق، لم تكُن أمي متفرّدة، فهذا كان شأن كل نساء بلدتي، حتى أني كبرت وأنا أحسب أنه حال كل النساء.
لم يكُن غريبًا على طفولتي أن أدخل مع ثُلَّة من الرفاق بيت إحدى الجارات، فنجد صاحبته منحنية على قدر يتّسع لاثنتين منا، وفي القدر ماءٌ بني تخرج منه حبّات «الظفور» (الأصداف أو القواقع)، التي نقعتها أيامًا في ماء تجدِّده كل صباح، وقد تخلطه مرة أو مرتين بثِفْل القهوة ليسحب الرائحة. ندور حول الجارة وهي تَكحت² اللحم من قلبه لتبقى القوقعة البنية الرقيقة والصلبة في آن. وبعد أن تزيله، تُعيد غسل الظفور وتجفيفها أيامًا تحت الشمس، ثم تحمّصها على النار لتبدِّد أية آثار للرطوبة باقية فيها. لاحقًا تُدَقّ كميات متساوية منها مع العود والجاوي التي هي أساسٌ للدخون.
قد ندخل بيتًا آخر، فنجد بضعة نساء متحلّقات حول قِدْرٍ فيه خليط عطري. تنغمس يد المرأة في الطيب وتخرج بكتلٍ نضّاخة فتشكّلها في كرات صغيرة، وترصّها في صحون بحجم صحن المفطّح، صانعاتٍ منها حلقات دائرية من الخارج إلى الداخل. وتصغر الحلقات وتضيق لتكتمل بَكْرَةٌ صغيرة في الوسط. الواحدة من هذه الكرات الصغيرة تُعطِّر البيت يومًا كاملًا، وسيجد ريحها من يمرُّ بجواره. تنتج النساء ما لا يقل عن سبعة صحون من الدخون تكون مؤونة سنتين أو ثلاث لنساء العائلة الواحدة.
للطفلة التي تشاهد بدت العملية سهلة للغاية، وضحكات النساء وأحاديثهنَّ المبتهجة ساعدت في تكثيف الوهم، لكنها لم تستوقفني لأفكر فيها فقط.
احتجت عمرًا لأعي أهمية هذا الإرث، ولأدرك سرعة تفلُّته من ذاكرة أجيال ما بعد الطفرة، اللاتي خَلق التعليم فجوةً بينهنَّ وبين إرثهن، واختطفهنَّ الإعلام بتقديس العطور الباريسية.
ففي أواخر الثلاثين من عمري هداني الله، وحاولت مرّة أن أجرّب المشاركة في إعداد بخورنا العائلي. لم أنجح في تكوير حبّة الدخون الأولى إلا بمشقَّة، وصمدتُ لأصل إلى نصف حلقة من كرات البخور. والنتيجة، آلام في عضلات يدي وتوتُّر في أعصابها ثلاثة أيام تالية. أما الظفور ودقة العود فكان تنظيف عوالقها تحت أظافري مُرهقًا.
في تلك الفترة تقريبًا، قرأت كتاب «أفروديت» لإيزابيل الليندي، فصُدمت، ولم يخطر ببالي أبدًا أنّ التراث الشفوي يمكن أن يصبح مادةً كتابية أنيقة (اعتدت حتى ذلك الحين على فصل العالمين)، ثم اجتاحتني الغيرة، وتمنيت لو أكتب عملًا مماثلًا عن طيب نساء الدواسر.
تعلن إيزابيل صراحةً أنها تطمح بأطباقها المُنكَّهة بالأشعار والحكايات والبهارات إلى إحياء الأيروسية عبر حُلَيمات التذوّق. أما جدّاتي فقد استَهدفن ببخورهنّ حاسّةً أقوى استجابة؛ حاسة الشم.
عرَفتْ البشرية التطيّب بتعطير الجسم حيًّا وميتًا، فوضعت الأعشاب العطرية أكاليلَ على الرؤوس، وحول الأعناق والسواعد، ودهنت الأجساد بأدهانٍ مُعطَّرة، وطوَّرت كل حضارة وصفاتها مع الزمن، مستفيدةً مما تنتجه أو تستورده.
ومع كل المراحل التي مرّت بها الصناعة، ظلَّت فكرة ارتباطها بالبخور في ضمير الشعوب، حتى اختار الفرنسيون للعطر كلمة «بيرفيوم»، المأخوذة من العبارة اللاتينية (per) وتعني «شامل»، و(fumus) وتعني «دخان» أو «من خلال الدخان». كيف لا وأوائل أشكال العطور المُركَّبة التي عرفتها البشرية كانت توضع في المجامر ليتحرَّر الطيب.
لا أعرف متى ظهر البخور، لكن الثابت أن الفئات العُليا من المجتمعات القديمة احتكرت استخدامه، فصار مُقدَّسًا. كما ارتبط بطقوس تتويج الملوك ودفنهم. ومع التوسّع في شرائح مستخدميه، انزاح البخور من علو المقدس لمرتبة أدنى كثيرًا، وإن لم يسقط ليغدو مدنَّسًا.
نلاحظ مثلًا أن البخور حاضر بكثافة في أغلب أسفار التوراة، وأنّ آيات عديدة فيه تُحدِّد مكوناته وكيف يُقدَّم، وأين، ولماذا، وأنه ركن أصيل في العبادة اليهودية. لكن وظيفته هذه ستتراجع في العهد الجديد، فتتناقص مرّات ذكر البخور في الإنجيل، وسيصبح البخور رمزًا للصلاة والتسبيح، لا فرضًا مُلزمًا. أما حين يظهر الإسلام فسيتراجع ذكره، بل لن نجد أي ذكرٍ صريح له في القرآن الكريم. غير الحث على التطيّب واستحبابه للذاهبين إلى الصلاة، خاصة صلاة الجمعة، وما ورد في السنة من استجمار³ الرسول عليه الصلاة والسلام بالألوة والكافور… لا غير!
إذن في مرحلة ما من عمر ثقافتنا، أحكمت أيدي النساء قبضاتها على المجامر، وجعلت البخور المتصاعد منها قرابين لذَّة ووسيلة لجذب العشير لمذابح العشق.

لماذا نشأ الدخون في الوادي دونًا عن حواضر الجزيرة العربية الأخرى وبواديها؟ ولماذا صنعت الدوسريات الدخون الذي إلى اليوم لا تصنعه نساء نجد الأخريات؟ سأرجع السبب لخاصيّتين: الأولى أن الدوسريات عرفنَ الاستقرار في أزمنةٍ أسبق، فهنّ بنات واحات النخل الثرية المستقرة. الخصيصة الثانية هي موقع الوادي على درب البخور القديم المُمتد من جنوب الجزيرة العربية إلى العالم.
سأزعم أن الثراء المادي مع الاستقرار ووفرة المواد العطرية المُستورَدة، مع ترف الفراغ، حفّز الحس الجمالي لنساء المنطقة فأنتجنَ أعطارًا لم أجد لها مثيلًا عند شقيقاتهنَّ النجديات أو في أنحاء الجزيرة العربية.
كان يمكن للدخون الدوسري -لو أنه نشأ في بقعة أكثر عناية بالاستثمار- أن يحظى بانتشار أكبر وأبكر، بينما تعامَل رجال الدواسر مع الدخون على أنه شأن نسائي يترفّعون عن الحديث عنه في مجالسهم إلى اليوم. فيما جعلته النساء وصفةً سريّة يتناقلنها شفويًّا. وتحرص عميدة كل أسرة على إخفاء مكون أو مكوّنين من خلطتها لتبقى مميزة.
فلنعُد لجذر وصفة البخور كما وردت في سفر الخروج: «وَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: خُذْ لَكَ أَعْطَارًا: مَيْعَةً وَأَظْفَارًا وَقِنَّةً عَطِرَةً وَلُبَانًا نَقِيًّا. تَكُونُ أَجْزَاءً مُتَسَاوِيَةً، فَتَصْنَعُهَا بَخُورًا عَطِرًا صَنْعَةَ الْعَطَّارِ، مُمَلَّحًا نَقِيًّا مُقَدَّسًا. فَتَسْحَقُ مِنْهُ نَاعِمًا جِدًّا، وَتَجْعَلُ مِنْهُ قُدَّامَ الشَّهَادَةِ فِي خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ حَيْثُ أَجْتَمِعُ بِكَ»
المكونات الجافة للوصفة؛ أظفار، لبان، مُّر، تبدلت مع الزمن، فلم يبقَ منها غير التثليث. في وصفتنا المتوارثة من قرون استُبدل اللبان والمر بمنتَجين من شرقي آسيا؛ العود، والجاوي الأندنوسي، لا أعرف سببًا لذلك، لكن أستطيع أن أخمِّن أن قوافل البخور التي نقلت اللبان والمر للهند والصين عادت من هناك بالعود والجاوي، وقرّرت نساء الوادي تجديد الوصفة – أما البخور الظفاري فما زال محافظًا على اللبان.
الاحتمال الآخر أن أمرًا طرأ فانقطع درب البخور فترةً لأسباب سياسية أو اقتصادية، ولم يكُن ممكنًا العيش بلا بخور، فاستبدلوا المفقود.
أما «ميعة العطور» التي ذكرها النص، فتشمل الصمغ العربي الذي يعمل على تماسك المكوّنات الجافة بعد دقِّها، إضافةً لتشكيلة من الزيوت العطرية التي تنوَّعت وتكاثرت لتعجن الدوسريات اليوم بخورهنَّ بما لا يقل عن عشرة أعطار، أهمها مسك الزباد والعنبر والصندل والحبشوش والوردي وأبو نفرة.. ومن هنا، لعلّ الصورة اتضحت حين أشرت للترف الذي يسمح بعمل هذا المنتج.
لا تكتفي الدوسريات بالبخور، فصنعن معه منتجات عطرية أخرى: الدخون، معمولًا ومبثوثًا، والفتشة والسحون والحمسة (والحمسة معادل موضوعي للفوّاحات الحديثة، بقطع من الظفور والشنة، تُحمص على النار ثم يُصبُّ عليها عطور معينة، وتوضع في إناءٍ في غرفة النوم، وتقلَّب بين وقتٍ وآخر لينتشر طيبها كلّما خبا). وقد استخدمن الورس لتلوين الملابس وتعطيرها، وخلطن العطور الزيتية بنسبٍ مختلفة لصناعة عطورٍ للجسد، وأخرى لفراش الزوجية، ورداء مخدة العروس.
الآن وأنا أكتب هذا المقال أشعر بالحرج من ندرة حضور البخور وغيره من أطيابنا التراثية في أدبي خاصة، وفيما كُتب منه في الأدب السعودي عمومًا.
لعلّ هذه المقالة اعتذار متأخر عن التقصير، وقد أصبح الدخون علامةً تجارية بكل ما تستدعيه تجاريّته من مزايا الانتشار والاستمرار، وعيوب الغش والتشويه. ولعل القليل الذي كتبته هنا يفتح شهية آخرين للإضافة والتصويب، أو يغري صاحبات الإرث بالحفاظ عليه في وقتٍ لم تعُد الأجيال الجديدة تعرف شيئًا عن الفتشة، وقد خَلَت غرف النوم من الحمسة، وبُليت الأردية وعطورها.
وهو مسحوق وَرْد وأعشاب عطرية مجفَّفة منقوعة في الطيب
تكشط
يُقصد بالاستجمار هنا استعمال الطيب والتبخّر به. مأخوذ من المجمر
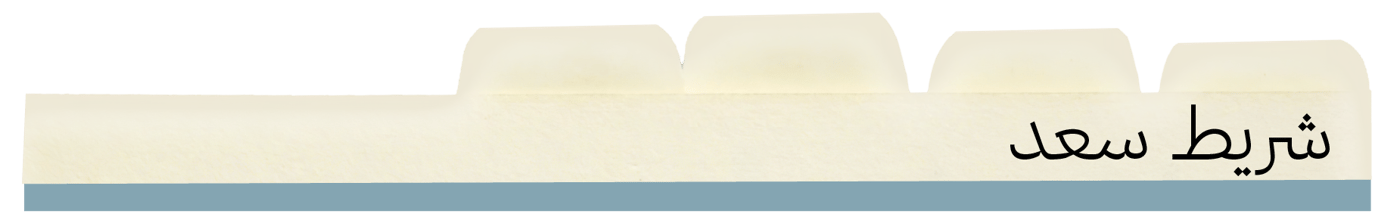

في هذا التسجيل من تسجيلات الدكتور سعد الصويان مع زعل بن مشعان الضويلي من أهالي موقق، بتاريخ 11 شوال 1405 ھ - 29 يونيو 1985م
أكثر ماتسمع من قصص الآباء والأجداد؛ قصص الجوع. وعلى كثرتها إلا أن استيعابها صعب. يذكر زعل في هالشريط مع الدكتور سعد «يقولون المسولفة» قصة مجاعة وأيام لحق آخرها. يتصدّر الحديث فعل ضايف المجولي وذبحة شاته لقريبته.
ثامر السنيدي
ادّخر بذكاء من كل عملية شراء 🧠
كل ريال تنفقه يمكن أن يصنع فرقًا في مستقبلك المالي. «ادخار سمارت» من stc Bank حساب ادّخاري يعطيك 4% أرباح سنوية وتقدر تسحب فلوسك بأي وقت! ادّخر اليوم، واستثمر في غدك مع
«ادخار سمارت».

عنيزة قطعة من الجنة!
وحنا جالسين بالغضا والليلة ظلما، ما غير ظلال النار على وجه معزّبنا حمد الحركان، التفت علينا وقال: الحين الجنة، وش أهم شيء فيها يخليها جنة؟
جاوب وقال: إن ما فيها بغضاء... هذا الشيء بعنيزة، عشان كذا العجوز يوم قالوا لها قولي يا الله الجنة، قالت يا الله عنيزة والجنة. عندها إن عنيزة مثال مُصغَّر من الجنة!


حمد الحركان هو فلاننا القادم بعشرة ديسمبر بإذن الله.
ثامر السنيدي




إذا تدور السمن المحجّر على أصول تلقاه عند زكي خان بسوق الديرة. يجيبه مخصوص من رنية.
عندك كروكي تحب نزوره؟
شاركنا توصيتك ✉️محمد السعدون



الذاكرة السعودية بالنص والصوت والصورة، في نشرة بريدية نصف شهرية، تعيد اكتشاف الثقافة المحلية وارتباطها بالعالم.